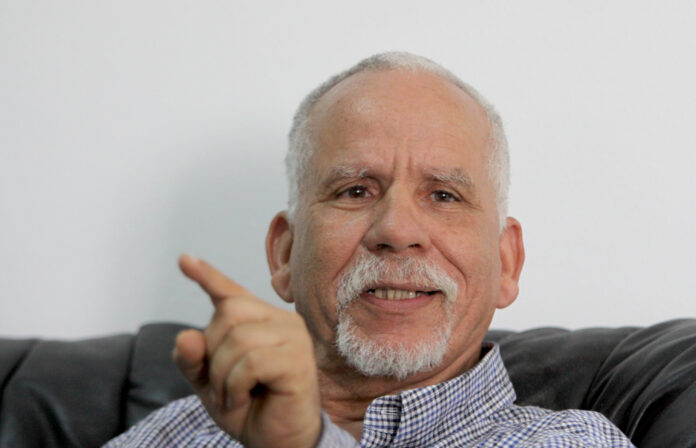حاوره: ابراهيم العميري – صور محمد كريم السعدي
أيّ منزلة للجامعي والمثقف في راهن المجتمع التونسي؟ وأي قيمة لمفكر اختار المعرفة والنقد مشروعا متكاملا يقيم الترابط الضروري بين النظر والعمل بين الخطاب والممارسة وجعل من ذلك خيارا متعقلا للتحرر والفعل الناجع في الواقع التونسي والإنساني؟ وهل يقدر الراهن الوطني الاستفادة من مناضل فريد في مساره العلمي والفكري وجريئا في مواقفه النضالية أن ينفتح على ما يقدمه من تصورات وأفكار غاية في الراهنية وغاية في مواكبة التغيرات الاجتماعية الوطنية منها أو الدولية؟
إن اللقاء بالمفكر المناضل والأستاذ الجامعي حميد بن عزيزة ورئيس جامعة تونس يعدّ فرصة ثمينة لأسرة منارات ولأسرة جريدة الشعب وقرائها لإبراز أهمية ما يقدمه حميد بن عزيزة من قراءات ومن رؤى نقدية لواقع النضال النقابي وشروط تطوره، وللوقوف عند الحقوق الاجتماعية، دلالاتها، سبل حمايتها وآليات تطويرها وتعزيزها، لتشخيص واقع العمل دوليا ومحلّيا ودور الدولة الراعية في تأكيد أولوية العدالة الاجتماعية وفي تأكيد مشروعية وأهمية الحضور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره يمثل مخبرا ثريا لتعميق حق المواطنة الفاعلة وتجذير قيم الديمقراطية بما تعنيه من حرية ونقد وعدالة ورقابة وقانون ومؤسسات دستورية متحققة.
حول هذه المسائل وحول شروط السؤال الفلسفي في ظل العولمة وحول دور المثقف العضوي اليوم في علاقة بالثورات العلمية باعتبارها أساسا للثورات الاجتماعية، وحول واقع الثقافة في تونس ودورها المحوري في تحقيق التقدم والتنوير والتحرر الجماعي قيميا وحقوقيا وسياسيا كان لنا هذا الحوار الهام مع المفكر والمناضل الجامعي حميد بن عزيزة.
يطرح حميد بن عزيزة افق الفعل النقابي في تمفصل ضروري مع الاجتماعي والسياسي والعلمي والثقافي وفي تضايف خلاق مع أسئلة الاقتصاد الراهنة وواقع المؤسسة الشغلية في ظل العولمة وفي تقاطع مع سؤال المعني وسؤال الإنساني.
القسم الأول: الجامعة، المجتمع، التفلسف، الكوني:
1 – المسار العلمي: في سؤالنا عن مساره العلمي بدا حميد بن عزيزة متحرجا حرج المتواضع في شموخ لكن أمام إصرارنا أن مساره العلمي كان مسارا طبيعيا بدأ من معهد كارنو اختصاص آداب ثم تواصل مع الإجازة فدكتورا الدولة فلسفة (اقتصاد الصحة) إضافة إلى شهادة الدراسات المعمقة في علم الاجتماع وشهادة الكفاءة المهنية التي تبقى راسخة في تجربة حميد بن عزيزة لأنها ارتبطت بعمل شاق في نسخ المؤلفات والبحث نفسه. انتُدب بعد ذلك مساعدا ثم أستاذا مساعدا بكلية الآداب القيروان، بعد ذلك التحق بكلية الآداب 9 فريل أستاذا محاضرا ثم أستاذَ تعليمٍ عالٍ، ليتولى بعد ذلك وعن طريق الانتخاب لا غير رئاسة قسم الفلسفة لدورتين وعمادة الكلية لدورتين وهو الآن رئيس جامعة تونس واحد. لقد أدار هذه المؤسسات بروح عالية من المسؤولية إذ أنه لم يتغيب يوما واحدا طيلة 12 سنة في مسؤولياته الإدارية المختلفة. وقد عمل في هذه المسؤوليات وفق مبدإ أساسي صاغه كالتالي: كيف تغادر المكان الذي دخلت؟ أي ما هي الصورة التي تتركها؟ ما الأثر الذي تقدمه لمن عمل معك ولمن سيأتي بعدك؟
أهم المؤلفات العلمية إضافة إلى المقالات والمحاضرات ومنشورات وحدة البحث «المعقولية اليوم» والمنشورات الجماعية نذكر بالخصوص:
– أطروحة المرحلة الثالثة: «منزلة السياسي عند ماركس بإشراف «برنار بورجوا» المفكر الفرنسي المعروف.
– أطروحة دكتورا الدولة: «المعقولية الاقتصادية والمعقولية الاجتماعية: نقد العقل الاقتصادي». وهو الآن رئيس جامعة تونس ورئيس ندوة رؤساء الجامعات.
2 -الجامعة التونسية والدور المنتظر: أي دور للجامعة في علاقة بقضايا المجتمع التونسي؟
في إجابته بين الأستاذ حميد بن عزيزة إن المهمة الاجتماعية للجامعة التونسية قد همشت، وأكد أن للجامعة وظائف عديدة منها إنتاج المعرفة، تبليغ المعرفة، المحافظة على المعرفة، ضمان تكوين جيل الجامعين ومن المهمات الأساسية للجامعة يؤكّد حميد بن عزيزة على المهمة الاجتماعية للجامعة وتتمثل في تقديم الأجوبة والحلول لبعض المشاكل الاجتماعية.
من زاوية أخرى بين حميد بن عزيزة في تفاعله مع السؤال حول وضعية العلوم الإنسانية في الجامعة التونسية إن دور هذه العلوم أكثر من ضروري فمن خلال هذه العلوم وبها نحلّل ونفكك ألغاز المجتمع، والفلسفة تأسست جوهرا وتاريخا على ملكة النقد والحرية في معناها العميق. وما النقد وما الحرية إذا لم يكونا انفصالا عن السائد والمألوف، إذا لم يكونا تجربة حياتية ينخرط فيها الإنسان بكل كيانه (أفلاطون)، إذا لم يكونا مشاركة وتدرّبا على المواطنة؟ إن جوهر الإنسانيات وحقيقة فعل التفلسف تخصيصا هو في بيان أن الحرية باعتبارها قيمةً تتحدد حين تتوضح الإجابة عن سؤال: «أي مكان لي بوصفي ذاتا تتحرر في هذا المجتمع؟ وكيف تتعايش مع حريات أخرى في هذا المجتمع؟ إن العيش معا يتطلب دربة وتربية والفكر الفلسفي هو الذي يضطلع بتدريب الناشئة على «فن العيش المشترك».
اليوم هناك تجديد لهذه الحاجة إلى الفلسفة وفي إشكال جديدة مثل المقهى الفلسفي، الجامعات الشعبية المفتوحة والتي لا تتطلب أي شرط للالتحاق بها وهو ما يمكن اعتباره عودة إلى الفضاء الذي نشأت فيه الفلسفة مع الاغريق: الساحة العامة أو «الأقورا» AGORA أي الفضاء العمومي المشترك (كانط، هابرماس). والغاية القصوى بالمعنى الكانطي للغاية هو إطلاق العقل من أجل المحاورة والحوار وجعل الحقيقة فعلا مشتركا تُبنى بتضافر الجميع (لا أحد يحتكر الحقيقة)، «الحقيقة مشتركة تبنى دون تسلط على البشر». ولأمر كهذا طالبت يقول حميد بن عزيزة، منذ سنوات بتدريس الفلسفة وتاريخ العلوم والابستيمولوجيا في كل الكليات وكل المعاهد العليا «إذ لا يعقل أن يتخرج طبيب أو مهندس وهو يجهل تاريخ اختصاصه».
فللعلوم أثر كبير في إحداث التغييرات الجذرية وفي تطوير المجتمعات الإنسانية فقد سمحت العلوم بتغيير التمثلات وبفضل النتائج العلمية تحولت وجهات النظر والرؤى. ومثال ذلك ما حدث في القرن 18: أمام ضغوطات الكنيسة حول تشريح جسد الإنسان نادى بيشا بعبارة مشروعة: «افتحوا الجثث»، وقد ثوّر هذا الشعار الطب والجراحة. مثال آخر ذكره فوكو حيث لاحظ أن كل المنحرفين في المجتمع (المتخلفين) يحشرون في نفس المكان أي يُعزلون ويسجنون: من هنا جاءت الفكرة لتخصيص فضاء خاص بالمجانين وهو ما ثوّر علم الحياة النفسية للإنسان بوصفه اختصاصا طبيا مستقلا. إن هذه الأمثلة من تاريخ العلوم وجب أن تكون معروفة لكل قاصد للجامعة. ويقدم هنا ايضا حميد بن عزيزة مثالا آخر حيّا عن أهمية تدريس تاريخ العلوم لكل الطلبة في الجامعات وهو المتعلق بالأطفال المشوهين(trisomie21) حيث طرح السؤال ماذا نفعل بهم؟ إذ رأى البعض ضرورة التخلّص منهم في حين نادى البعض بضرورة إدماجهم في المجتمع والمحافظة عليهم. المسألة أنه في ذلك العصر لم يكن الناس على معرفة بما سينتجه العلم في القرن 20 باكتشاف الحامض النوويADN: لقد اكتشف العلم في القرن العشرين الحقيقة التالية: «الطبيعة تخطئ» وهو خطأ إملاء، يكفي أن نصلح هذا الخطأ حتى نأتي على شفاء المريض (وهذا هو الفرق بين القرن18 والقرن 20). نستنتج مما سبق أن المعرفة العلمية تقدم الحلول والتصورات وتدفع العقول نحو التفتح ورفض الانغلاق.
3 – أزمة القيم وسؤال المعنى اليوم: أي مقاربة يقدمها الفيلسوف اليوم لما يطرح من جدل حول موت الإنسان أو أزمة القيم والمعنى؟
يبين هنا حميد بن عزيزة إن خاصية الإنسان الأولى هي وضع التمثلات وإنشاء ما يطلق عليه اسم المخيال الجماعي أو يعرف الرموز (كاسيرر) أي جملة التصورات والتمثلات والأحكام والقيم التي يحملها أفراد المجتمع حول وجودهم. والإنسان قيمي بطبعه أو هو كائن المعنى أساسا (‹نيتشه). إن عودة التفكير في القيم وطرح سؤال المعني اليوم هو تعبير عن شعور بغياب المعنى في الوجود الإنساني وخاصة بحالة الفراغ الكبير في حياة البشر. وللبحث في مبررات هذه الوضعية الانسانية بين حميد بن عزيزة انه بعد الطّفرة الرأسمالية الكبيرة وما احدثته من اضطرابات في وجود البشر، إذ أدت إلى تشيّؤ وجودهم (أدورنو وماركوز) وأصبح الإنسان مضطهدا ومغتربا ومدفوعا إلى حلبة الاستهلاك بما يعنيه من تحويل الإنسان إلى بضاعة وربما أرخص بضاعة، ولأن هذه المعضلة لم تعد ممكنة فالإنساني ليس بضاعة، الإنسان غاية، الإنسان أمل وطموح. لنتذكر هنا، يؤكد حميد بن عزيزة، عند كانط أن شرط حرية الإنسان أنه كائن فانٍ وأن قوة الإنسان في كونه ينتمي إلى عالمين علم الضرورة أي الحتميات وعالم الحرية والغايات القصوى. إن جوهر فلسفة كانط هنا يمكن تلخيصها في دعوته لمعرفة الحدود أي في أهمية رسم حدود إمكان النظر وحدود إمكان الفعل (تقد العقل الخالص) وحدود إمكان الحكم الجمالي. وبهذه الشكل يمكن القول إن كانط يؤسس لفكرة الجمهورية أي يجسد فكرة القانون، فكرة المؤسسات، المواطنة، الحرية…
لا ننسى أن الحداثة في معناها الأصلي تجسيد لأربع مبادئ رئيسية،
· المبدأ الأول : الإنسان هو ما يعمل
· المبدأ الثاني : الإنسان يعمل في محيط تقني وعلمي (أهمية الثورة العلمية)
· المبدأ الثالث: هذا الإنسان يعمل ضمن بناء مؤسسات، ضمن القانون
· المبدأ الرابع : العقل هو المتحكم في كل مسارات الحياة الإنسانية، لذلك وجب اليوم استئناف هذا المفهوم الأصلي للحداثة.
· 4 – المشترك الإنساني أي رهان؟ إي دلالة للإنساني أو للكوني في ما يحيل عليه من قيم إنسانية مشتركة كالحرية والعدالة والمساواة والتضامن؟
في تفاعل مع هذا التساؤل أشار حميد بن عزيزة إلى كتاب فوكوياما «نهاية التاريخ» علامةً على ما تشهده الإنسانية من واقع الهيمنة في مستوى فرض التأويلات الأحادية المجانبة للصواب. هذا المؤلف وغيره كثير (هانتغتون «صدام الحضارات») تندرج ضمن ما يمكن اعتباره إرادة فرض تاريخ حضارة واحدة: فالتاريخ هو تاريخ الغرب لدى فكوياما لذلك فهو يقصي الشعوب الأخرى من هذا التاريخ (هذا التوجه قد يكون في علاقة بما أشار إليه هيجل، مع بعض الحذرهنا، حول مفهوم «الشرق»). في كل الحالات هناك تأكيد وفق هذه القراءة للتاريخ على «انتصار التاريخ الغربي وخروج الحضارات الأخرى.
إن الخوف اليوم هو أن نكون نحن قد ساهمنا في هذه الوضعية، وإن نكون قد بقينا سجناء لمقولة المجد القديم في حين كان علينا أن نتسابق من أجل افتكاك مكاننا في الكوني، في العالم: إن الإحساس الطاغي اليوم هو «الإلهاء» الكبير للمسلمين بقضايا هامشية مفبركة مفتعلة من الآخر، وكأن قدرنا أن نبقى سجناء لمثل هذا النوع من الفكر وهذه الصيغ وهذا السجن الذاتي.
القسم الثاني: النضال النقابي ورهان المستقبل:
في هذا القسم اخترنا معالجة الملف الرئيسي لهذا العدد من «منارات» والمتعلق بدور النقابات اليوم وبدور الاتحاد العام التونسي للشغل تحديدا في بلورة بدائل للمشكلة الاجتماعية، لحق العمل اللائق، لمفهوم الدولة الراعية للمسألة الاجتماعية والمحققة للعدالة الاجتماعية والجبائية. وهو ما دفعنا إلى توجيه السؤال مباشرة للأستاذ حميد بن عزيزة: أي دور للاتحاد وللنقابات في مواجهة تحديات «عالم العمل بكل ما يحمله من معضلات جديدة تتعلق بالعمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في مواجهة واقع العولمة؟
بين حميد بن عزيزة أن هذا السؤال هام وصعب وهو محرج لأنه مرتبط بالمسألة الاجتماعية منذ بروزها في القرن 19، وهو صعب نظرا لإلى التغيرات الحاصلة اليوم وما تطرحه من ضرورة إعادة التفكير في العمل بأدوات جديدة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية وجب الوقوف عند المقارنة التالية في علاقة بمنزلة الاتحاد العام التونسي للشغل: مقارنة مع الأحزاب لماذا هناك بروز للنقابات في التحركات الشعبية الكبيرة وتقلص لدور الأحزاب الكلاسيكية؟ الإجابة حسب حميد بن عزيزة بسيطة ولكنها عميقة في معانيها ورهاناتها: التفسير المنطقي والتاريخي لذلك هو أن «النقابات أكثر حرية ومرونة وأكثر التصاقا بمشاغل المواطنين». لذلك ليس هناك مفاجأة كبيرة إذا رأينا أن الاتحاد العام التونسي للشغل حاضر بكثافة في الحراك الإيجابي للاحتجاج وفي الدفاع عن كل القضايا التي تشغل بال التونسيين.
لكن اليوم حصلت تغييرات كبيرة في العالم، تختزل هذه التغييرات في ما تحيل عليه كلمة «عولمة» وكل تبعاتها: عولمة الإنتاج، تحطيم الحواجز، تجانس السلوكات الاستهلاكية والحياتية، والأخطر هو خوصصة حياة االأفراد. إن هذه الوضعية تضعنا أمام صعوبة كبيرة مازالت موضع حوار ونقاش وتساؤل وتشخيص.
تعد المسألة الاجتماعية قضية ومحور الحركات الاجتماعية والثقافية منذ القرن18، وهذه المسألة (أي غياب الحماية الاجتماعية وما تؤدي إليه من عبودية واستغلال) تحيل إلى الخلل الحاصل في المجتمع الصناعي الحديث. ولقد سمحت مكاسب النضالات الاجتماعية بتغيير جذريّ في نمط حياة الكادحين في القرن19. ولا شك في أن بروز ما يُسمّى بالدولة الراعية كان نتيجة مباشرة لهذه الظاهرة : الانتصار على حالة اللأمن الاجتماعية والتخلص من الخوف من المستقبل. وساد الاعتقاد بعد الحرب العالمية الثانية وبعد «الثلاثين السعيدة» les 30 glorieuses بأن الإنسانية تتجه نحو القضاء على حالة الفقر والحاجة وإنه بإمكاننا تحرير المجتمع وحماية الأفراد من المخاطر.
لكن مع بداية السنوات الثمانين للقرن20 وأمام نموّ ظاهرة البطالة وبروز أشكال جديدة من الفقر والهشاشة ساد شعور بأن ما كان يعتقد فيه هو مجرد سراب. لا يتعلق الأمر هنا بالعودة للماضي لأن الظواهر الحالية للإقصاء والتهميش لا تماثل أنماط الاستغلال القديمة، وأن حلّها يطرح علينا تفكيرا جديدا لأشكال مغايرة: إن الأمر يفرض نمط تفكير جديد لمسألة اجتماعية جديدة تترجم عدم تلاؤم المفاهيم القديمة لتدبير أمر الاجتماعي. لقد أصبحت أزمة الدولة الراعية حاملة لأزمة مغايرة طارحة لمعان جديدة لفكرة التضامن والمكاسب الاجتماعية المهددة. وهكذا أصبحت المسألة الاجتماعية مسألة فلسفية أساسا تحدد كل المواقف والتصورات والاستراتيجيات والتساؤلات حول نجاعة جهاز التوزيع وحول تصور أشكال التنظيم والتصرف في نمط هذه الدولة الراعية. الراهن الإنساني اليوم يكشف عن مشكلتين رئيسيتين في علاقة بعالم العمل وما شهده من تغييرات جذرية:
· تفكك المبادئ المنظمة للتضامن
· فشل التصور التقليدي للحقوق الاجتماعية (ويتجلى ذلك خاصة في الصعوبة المتعلقة بتحديد إطار معقول للتفكير في أوضاع المقصيين والمهمّشين والمحرومين أو ما يطلق عليهم «بدون»: دون مأوى، دون عمل، دون إقامة…)
يمكن التأكيد باختصار هنا أن الأزمة الاجتماعية الكبيرة التي تعمقت منذ 1980 جعلت مطلب تدخل الدولة و تبربره متداولا من جديد، وهذا يعني رفض ايديولوجية «الدولة-الدنيا» وما تقوم عليه من منحى للتخلي عن كل دور اجتماعي. إن هذه المشروعية الجديدة للدولة باعتبارها ضامنا للحيطة الاجتماعية هي ما نشاهده اليوم في تونس وكل البلدان. إن الواقع الإنساني اليوم في علاقة بالمسألة الاجتماعية يعالج الإشكال التالي: كيف نفكر في الدور الجديد للسياسي؟ وكيف نؤسّس من جديد لمشروعية هذه الدولة الراعية ؟
يبرز هنا حميد بن عزيزة وجود حقيقة لا يمكن تجاهلها: تفكك آليات إنتاج التضامن المجتمعي وكل خوفي يؤكد حميد بن عزيزة، «أن يكون هذا التفكك نهائيا». لقد قامت هذه الآليات على فكرة نظام التأمينات الاجتماعية، أي تأمين التضامن على تقاسم المخاطر والتشارك الإرادي في هذا التقاسم. المشكل اليوم هو الفصل المتنامي بين الحماية الاجتماعية والتضامن، الانفصام المتنامي بين المساهمين والمنتفعين وهو انفصام يعمق الصعوبات.
لم يعد التصور التقليدي للحقوق الاجتماعية يتلاءم مع بروز «المشكل-الجوهر» المتعلق بالإقصاء أمام تقلص فرص الشغل بشكل موضوعي وما يحمله هذا التقليص من مشاكل وتبعات تؤثر بالضرورة في استراتيجيات النقابات. إن المأساة اليوم ليست نظرية: يمكن أن يبقى الشخص دون عمل مدى الحياة (زمن نهاية العمل). هذه الوضعية المعضلة دفعت البعض إلى الحديث عن ضرورة إيجاد نمط تنمية جديد لأن النمط الحالي أبرز حدوده، أما البعض الآخر فقد بين أهمية تجسيد التمييز الإيجابي للحدّ من التفاوت، في حين نادى آخرون بالاستثمار. لكن المشكل أن لا أحد من كل هؤلاء نبه إلى هذه الظاهرة: التقلص الموضوعي للشغل وما يطرحه من إحراجات نظرية وعملية. والغريب أننا في تونس ننتبه دائما متأخرين إلى حيوية هذه القضايا: ففي حين يتحدث الغرب عن دخل اجتماعي منفصل عن الشغل (أو ما يسمى أجر مقابل الحياة) مازلنا في تونس لم نحلّ مسألة ضمان فقدان الشغل أو البطالة. والأغرب أن اليوم وفي العديد من بلدان العالم تطرح وتناقش من جديد المسألة الاجتماعية بالتشريع لما يُسمّى «مقابل كلي للحياة allocution universelle de vie» «دون مرجعية شغلية، مازلنا في تونس نتنافس من أجل وظيفة إدارية بل نتفنن في إيهام العاطلين عن العمل بأن الغد سيكون أفضل وأن فرصتهم في الشغل ممكنة.
يحوصل حميد كل ما سبق بقوله : «هذه هي المحطات الكبرى لتفكير استراتيجي للنقابات اليوم، والاتحاد العام التونسي للشغل مطالب بالتأقلم مع هذه المتغيرات. تقليديا النقابة تدافع عن حق الشغل عن المشتغلين وأمام الوضع الجديد يتعين على النقابات أن تفكر بأدوات جديدة في حلّ المسألة الاجتماعية. أما في تونس فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل المدرسة الأولى الذي ينبغي عليها حلّ هذه المعضلة أو المساهمة الفعلية في حلّها. نحن اليوم لا نعرف مثلا مهن الغد التي تتغير بسرعة عجيبة وحتى اتحاد الصناعة لا يملك خارطة لمهن الغد. فما عسانا نفعل يتساءل حميد بن عزيزة؟ ما ينبغي القيام به حسب رأيه هو العمل بنصيحة «داروين» حيث بين أنه أمام مشكل ما الإنسان له ثلاث حلول: إما أن يتأقلم وإما أن يهاجر وإما أن يندثر»، ولا وجود لحلّ آخر.
القسم الثالث: الثقافي والاجتماعي السياسي:
أي مقام للثقافة في مجتمع ديمقراطي؟ إن مفهوم الثقافة بما يحيل علية من تعدد التعريفات والمجالات لا يجد أهميته حسب حميد بن عزيزة إلا داخل مجتمع ديمقراطي فتواتر التساؤل حول الكتاب، حول ما يوزع ثقافيا حول أزمة القراءة حول الإبداع هي في النهاية أسئلة حول الثقافة مما يدفعنا إلى أن نقابل بين مجتمع ديمقراطي ومجتمع لاديمقراطي. في المجتمع اللاديمقراطي الثقافة موجهة إلى النخبة أما في المجتمع الديمقراطي فهي للجميع لا حقوقيا أو تشريعيا بل سوسيولوجيا: إنها التربية المعممة، ثقافة للجميع، إعادة إنتاج نمط معين في المجتمع. فأين نحن من أنماط ثقافية متلائمة مع عصرها، ثقافة عقلانية للغد؟ هناك خطر في الحديث عن الثقافة في المطلق.توجد ثقافة جيدة وثقافة رديئة مثلما يوجد كتاب جيد وكتاب رديء. كلنا يعرف مقام الثقافة الجماهيرية في البلدان الاشتراكية. إن السؤال الفلسفي في علاقة بالثقافة هو التالي: هل توفرت الشروط السليمة والضرورية لنشأة عمل ثقافي مالك لفكرة تزرع في المجتمع؟ هل هذه الشروط هي التي تحدد صلوحية الثقافة أم أن الثقافة تعبر دوما عن مصالح طبقة مهيمنة في المجتمع؟ إن جوهر الثقافة التزام بالنسبة إليّ؟ نعرف جميعا التقابل الحميمي طبيعة/ثقافة. لكن ينبغي ألاّ ننسى دائما التوتر الموجود بين المعطى (الطبيعة): مقاومة والثقافة هي التي تأتي على هذه المقاومة. الثقافة هي التي تحمي الإنسانية من النسيان فالثقافة ذاكرة الشعوب المتوثبة للمستقبل، والفنان الحديث يبحث عن رسم حياته وأفعاله وأقواله ثقافيا. ويبين حميد بن عزيزة أن نفس الصعوبة تعترضنا حين نشخص مفهوم الديمقراطية. فظاهريا الكل متشبع بالديمقراطية والكل يعود لأصل الكلمة: حكم الشعب لنفسه بنفسه. ففي أي بلد نقف على حكم شعب أو سيادة شعب؟ تطرح هنا إشكالية غاية في الأهمية حول حدود نظام الحكم التمثيليREGIME REPRESENTATIF؟ اليوم يُثار السؤال التالي: كيف نعيد الاعتبار إلى هذا البُعد التمثيلي حتى نقضي على المسافة بين الناخب والمنتخب إذ غالبا ما يتنكر المنتخب للناخب؟ إن مقولة الشعب سيد نفسه بما هي أسّ الديمقراطية تتحقق حين يضع المجتمع القوانين أي يؤسس لذاته قانونيا ضمن مبدإ الاستقلالية ومبدإ الحرية. فالحرية لا قيمة لها دون هذه الأطُر والدستور وحقوق المواطنين تقوم على القانون. والفرد داخل القانون يضع قيما: حدودا، دلالات. ونتيجةً لكل ذلك المثقف اليوم ليس ذلك الخطيب بل هو ذلك الذي يساهم في فتح الممكنات، وهذا بالضبط ما بلوره «غرامشي» ، فالمثقف العضوي بالنسبة إليه هو من يندمج إراديا في المجتمع من أجل لباس مشاغله وهمومه وتطلعاته للحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية. المثقف الأصيل اليوم هو، في تساوق مع «غرامشي»، من يعمل على انتصار هذه القيم داخل المجتمع وهو ما يسميه «غرامشي» الهيمنة الثقافية التنويرية: ليست هيمنة في المطلق بل انتصار لقيم الحرية والحداثة والمساواة. لذلك لا وجود لثقافة إلا ملتزمة، ملتزمة بقضايا الإنسان وبالنوع الإنساني.