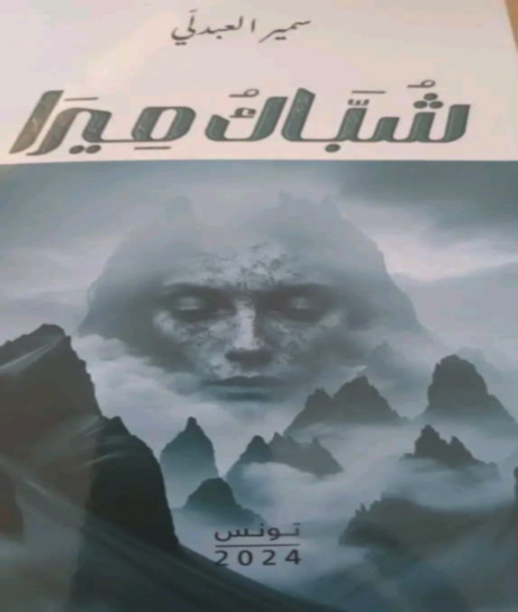رياض خليف
يبدو صوت سمير العبدلي مميزا في الشعر التونسي، بقصائده التي تقطع مع الرتابة وتحرص على شد القارئ بما تحمله من نسج للصور الشعريّة، محوّلة اليومي البسيط إلى شعريّ جذاب. ولا يختلف الديوان الشعري الأخير عن هذه الملامح. فالشاعر يأتي حزينا ولكنه يضخّ في القصائد الكثير من الصور.ويلمس قارئ هذا العمل حضورا بارزا لمعجم الموت ولمناخاته، ويبدو ذلك منذ العتبات النصيّة وتحديدا عتبة الإهداء: “أبي، إلى روحه في رحلة الغياب”، وهي إشارة إلى هذا المناخ الشعري الذي يتردد أيضا في عتبة بعض العناوين الداخليّة التي يبرز بين طيّاتها لفظي الموت والحزن، (الموت فكرة رائعة/ سلالات الموت/ بدعة الموت/ يشرق من حزننا/ حدائق الأحزان/ قلبي يسع كلّ هذا الحزن/.) إضافة إلى تواتر مفردات وجمل تجيل على نفس المعجم داخل أغلب القصائد.
يفهم هذا التوجه بانفعال الشاعر اثر وفاة والديه وهو ما انعكس على نصوصه، لكنّه يحيل كذلك على إنشائيّة الموت في القصيدة الشعرية الحديثة، وهو مبحث تناوله عدد من الباحثين. فلقد أصبح خطاب الموت نقطة اهتمام نقدي، لا بصفته خطاب حزن ورثاء وتفجع مثلما عهدناه في الأدب القديم ولكنه ينفتح على آفاق أخرى. فهو بحث عميق وطريف في الموت ومتابعة جميلة للعبة الموت والشعر، فالشعر يطارد الموت ويطوّعه لخدمة القصيدة وتوليد صور طريفة ومعان متميّزة. ولعل هذا ما يمكن تسجيله في تجربة سمير العبدلي الذي لا يقصر كتابته للموت على التفجّع بل يتعداها، لتبدو قصائده حاملة لنوع من التحدي له والسخرية منه.
كرنفال الموت:
تتحول كتابة الموت في جانب من قصائد سمير العبدلي إلى كتابة كرنفالية بهيجة، محتفية بالحياة، متجاوزة طقوس الموت. فلا تخلو مشاهد الموت الشعرية من مرح وعبث:
” رأينا راقصة الفلامنجو
رأينا المتنبي ولوركا
رأينا مساجد الموصل ومآذن كربلاء
رأينا نادل الحانة وبائع الفول…” “
إنّ الشاعر يلوّن عوالم الموت بعوالم الحياة البهيّة، منتصرا بلغته على سوادها وأوجاعها، مشكّلا مشهدها من عوالم الرقص والفن والشعر والمجالس، وهكذا تبدو كتابة الموت كتابة بطعم كرنفالي احتفالي متحرر من اللحظة ونواميسها.
لكن هذه الكتابة تنفتح على خطاب واصف، هو خطاب الشعر عن الشعر، فيشير الشاعر إلى معاناة الكتابة الشعرية ومكابدتها:
لا يعرفون
كيف تقتنص القصائد
وكيف يذبحنا الكلام
الشعر؟
لو يدرون مزرعة الخطيئة
وبابها العالي
هذا الرّبط بين الموت والشّعر، الداخل في الخطاب الواصف يظهر في مواقع مختلفة. فالشاعر يخاطب ذاته الشاعرة أحيانا خطابا تتداخل فيه مفردات الموت مع مفردات الشعر:
الموت تمثال الحقيقة/ وظلّها العاري/ الحب إذن/ لست نبيّ لقوم/ ولست حارس المعنى/ أنت سليل الحالمين. في المجاز/ وفي القصيدة.
إنّ الشاعر يوطّد الصلة بين الشعر والموت:
“الموت سجّاد القصيدة… “
هذا الاتجاه نحو استعادة صوت الشاعر في مناخ جنائزي وإظهاره في موقع قوة يهزم طقوس الموت هو جزء من خطاب تحدّ يمارسه العبدلي، ولكن كتابة الموت تتّجه أيضا نحو الذاكرة، معيدة كتابة الحياة بعد حوادث الموت.
الموت والذكرى:
يأخذ حديث الموت الشاعر إلى الذكرى فيتوغل في الذاكرة مستعيد بعض التفاصيل اليوميّة على غرار ما نجده عن أمّه:
وكنت أنا كلّ يوم أراها تنام..
هذا التذكّر يبدو أيضا في قصيدة صباح الخير حيث يذكر الأب، معتمدا تقنية الحلم:
لمحته البارحة يمدّ أصابعه لزهرة لوز/ ربّما هو الآن زهرة في حقول الأرض/ أو ربّما هو الآن في غيمة في السماء.
وتنهال الذكريات حاملة مشاهد من الذّاكرة ومن اليوميّ، فيستدعي أشياء الذاكرة وفضاءاتها:
تركت خلفي رائحة البنّ في الفيراندا المطلّة على تلال الزيتون
تركت خلفي
أصص النعناع والصبّار والحبق.
تركت المآذن والمقاهي والساحات
تركت السبالة الظهريّة…
إنّ الموت في هذه الأبيات رحيل نحو الحضن الأمومي، نحو فضاءات الحياة الأولى، فنجد صورا للبيت والحقل والقرية بملامحها المرجعية ( قرية يبدي علي بنعون موطن الشاعر )
وكالعادة يرتبط خطاب الذاكرة والموت بالشعر:
تركت أسمائي وأشيائي وقصائدي الأولى.
هكذا غدت كتابة الموت لونا لإثراء جماليّات القصائد التي عجّت بمظاهر اليوميّ. وهذا ما ينطبق على هذا الديوان الذي يحمل توقيع سمير العبدلي وكذلك بصماته الشعريّة الراسخة، كاتبا لشعر يتداخل فيه النفسي مع اليومي والعائلي، جامعا بين أصداء المدن ورائحة القرى…