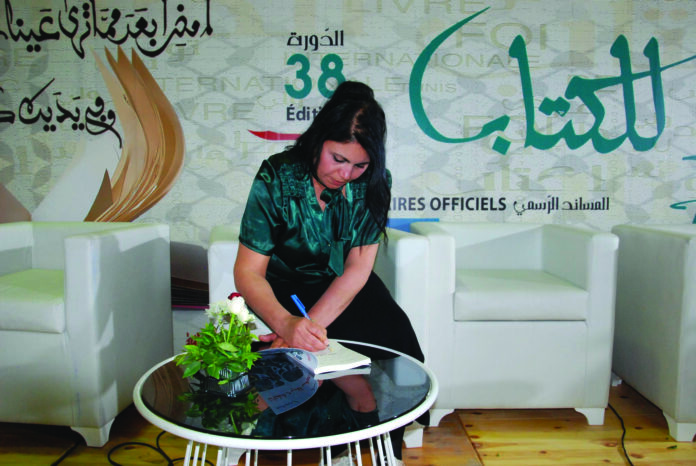حاورها: عمّار الطيب العوني
في عالمٍ تتنازعه السرعة والسطح، تكتب وحيدة المي كما يُكتب الضوء على صفحة الروح: بتؤدة، وقلق، وتوهّج داخلي. صحفية وناقدة وروائية تونسية، اشتغلت في الصحافة الثقافية والبحث الأكاديمي، ثم شقّت طريقها في الكتابة السردية بحسٍّ أنثوي جريء ومتماسك. صدرت لها روايتان: “نوَّه” و**”رغبة بيضاء”**، تمثّلان لحظتين مختلفتين في مسيرتها، لكنّهما تلتقيان في ذلك القلق الكاشف، وفي ذلك التواطؤ العميق مع الأسئلة المهملة.
بين “نوَّه” و”رغبة بيضاء”: رواية الجسد والظلّ
س: من هي “نوَّه”؟ أهي بطلتك أم ظلّك؟ أم أنها مرايا تتكسّر ليظهر ما نخفيه عادة؟
وحيدة المي:
“نوَّه” لم تأتِ من فراغ. كتبتها وأنا أكتب عن أنثى تصرخ دون صوت، وتنتظر دون مواعيد. هي ليست فقط بطلة روائية، بل جرحٌ مفتوح في الذات النسائية العربية. تربّت في بيئة تحاصر الأحلام، ثم اختارت أن تنفجر من الداخل. في كل سطر، كانت “نوَّه” تتعلّمني كما أتعلّمها. كلتانا خرجنا من الكتابة متعبتين، ولكن حقيقيتين.
س: تبدو روايتك “نوَّه” مشغولة بالتفكيك: تفكيك الجسد، الذاكرة، السلالة. هل كان ذلك وعيًا نقديًا أم انسيابًا سرديًا؟
وحيدة المي:
في الحقيقة، لم أضع خطة أيديولوجية مسبقة. أنا أؤمن بأن الجسد هو النص الأول، والكتابة عندي هي حفر في الطبقات، لا استعراض لمواقف. نعم، ثمّة وعي بأن كل أنثى هي مشروع سردي معقّد، وأن المجتمع لا يكتب النساء بل يمحوهنّ. “نوَّه” كانت تمرينًا على الظهور، على الإفلات من المحو، حتى لو عبر الشقوق.
س: ننتقل إلى روايتك الثانية “رغبة بيضاء”، التي حملت نبرة أكثر هدوءًا، لكنها لم تخلُ من الاشتعال الداخلي. كيف ترين التحوّل بين الروايتين؟
وحيدة المي:
“رغبة بيضاء” كُتبت في مناخ مختلف. كنتُ قد تصالحتُ مع بعض الجراح، أو على الأقل، اعتدتُ على وجعها. هي رواية الظلال، لا الصراخ. تنبني على همس العلاقات، على شهوة اللغة، وعلى ما لا يُقال. بينما “نوَّه” كانت كتابة على الجدار، “رغبة بيضاء” كتبتُها كما يُكتب السرّ في دفترٍ مغلق. لكنها لا تقلّ قلقًا. الفرق فقط في نبرة التعبير.
س: في الروايتين، تتجلّى علاقة اللغة بالجسد، لا كأداة وصف بل كموقع للمعنى. كيف تنظرين إلى هذه العلاقة؟
وحيدة المي:
أعتقد أن الكتابة التي تفصل اللغة عن الجسد تفقد الكثير من صدقها. أنا أكتب بجسدي، أتنفّس من خلال الكلمات، أرتعش وأنا أضع النقطة الأخيرة. اللغة ليست زينة ولا وسيلة نقل، بل هي كيان عضويّ يتورّط في الحياة. الجسد لا يقول وحده، واللغة لا تنطق إلا بجسارة اللحم والذاكرة.
س: هل ترين الكتابة عندك نسوية بالمعنى السياسي؟ أم أنها انحياز للإنسان المهدور، مهما كان جنسه؟
وحيدة المي:
أنا لا أكتب لأرفع شعارًا، بل لأفضح واقعًا. إن كانت كتابتي تُصنَّف نسوية، فذلك لأن الواقع العربي لا يزال يهمّش المرأة، لا لأنني أردتُ تسويق خطاب جاهز. الرواية عندي تنحاز للإنسان الذي يخسر المعركة كل يوم، سواء كان امرأة أو رجلًا هشًّا أو طفلًا مجهولًا. لكن لا أنكر أنني أكتب من موقع أنثوي، لا بمعنى البيولوجيا، بل بمعنى الحساسية.
س: لو طلبتُ منك تلخيص تجربتك السردية في جملة واحدة، ماذا تقولين؟
وحيدة المي:
أكتب لأن في داخلي صمتًا يجب أن يُقال، وجسدًا يريد أن يصير صوتًا، وروحًا لا تهدأ إلا حين تلمس الحبر.
س: ما الذي تكتبينه الآن؟ وهل سنشهد ولادة عمل ثالث يواصل هذا المسار؟
وحيدة المي:
أنا أكتب دائمًا، حتى في الصمت. الرواية الثالثة تتشكّل على مهل. لا أستعجلها. هي عن امرأة تبحث عن أمّها المفقودة، لكن في الحقيقة، هي عن وطن يبحث عن ذاكرته. لا أعرف متى أنهيها، لكنني أعرف أنها لن تكون أقلّ ألمًا من سابقتيها.
الكتابة بين العاجل والدائم: وحيدة المي تتحدث عن الصحافة كمعبرٍ إلى الرواية
س: عملتِ في الصحافة الثقافية لسنوات، وكنتِ شاهدة على تحوّلاتها. كيف ترين العلاقة بين الصحافة والأدب؟ هل هي علاقة تغذية أم استنزاف؟
وحيدة المي:
عشتُ الصحافة بوصفها مخبرًا يوميًا لاكتشاف اللغة والناس والزمن. كانت مدرسة قاسية، لكنها ضرورية. أحيانًا تشبه الصحافة الركض، بينما تشبه الرواية التأمل. هذا التوتر بين العاجل والدائم أنضج لغتي. تعلّمت من الصحافة كيف أختصر، كيف أُصغي، كيف ألتقط الفكرة وهي تمرّ كطيف. لكنها، أحيانًا، تستهلكني: تستنزف وقتي وحساسيتي. فحين تكتب يوميًا عن الآخر، تنسى أن تُنصت لنفسك. لذلك، كنت أعود إلى الرواية كمن يعود إلى جسده بعد اختطاف طويل.
س: هل تجدين أن الصحافة الثقافية اليوم لا تزال قادرة على إحداث أثر؟ أم أننا نعيش زمن الضجيج بلا صدى؟
وحيدة المي:
نحن نعيش زمنًا هشًّا ثقافيًا، حيث صار الانتباه سلعة نادرة. كثير من المنصّات تتعامل مع الثقافة كديكور، لا كمساءلة أو عمق. ومع ذلك، لا أنكر وجود تجارب تُقاوم، تُراكم، وتكتب باحترام. الأثر اليوم لا يُقاس بعدد القرّاء، بل بعمق السؤال. والكتابة الثقافية الصادقة تظلّ ضرورة، حتى لو كتبنا في العتمة.
س: هل أثّرت مهنتك الصحفية على طريقتك في بناء الشخصيات الروائية؟ هل ساعدتك في فهم الناس والإنصات لهم؟
وحيدة المي:
بالتأكيد. العمل الصحفي، خاصة حين يكون ميدانيًا وإنسانيًا، يجعلك تخرج من برجك الداخلي. تصبح أكثر تواضعًا، أكثر وعيًا بتعدّد الحكايات. حين أكتب شخصية روائية، أستدعي كل من التقيتهم: امرأة من الجنوب تحمل العالم في نظرتها، كاتبًا مهمّشًا يكتب دون أن يُقرأ، عجوزًا يتكلم عن الحرب كما لو أنها حلم سيئ. هذه الأرواح تبقى، تترسّب، ثم تظهر على الورق دون استئذان.
س: من موقعك ككاتبة وصحفية، كيف ترين صورة المرأة في الإعلام العربي؟ وهل تغيّرت برأيك؟
وحيدة المي:
تغيّرت الصورة من حيث الشكل، لا من حيث الجوهر. صرنا نرى نساءً أكثر على الشاشات وفي المقالات، لكننا نادرًا ما نسمع أصواتهنّ الحقيقية. الإعلام لا يزال يعيد إنتاج أنماط جاهزة: المرأة الضحية، المرأة الزينة، المرأة الخارقة. ما نفتقده هو المساحات التي تقول فيها المرأة ذاتها كما هي: معقّدة، متناقضة، عادية واستثنائية في آنٍ معًا.
س: لو خيرناك بين لحظة في غرفة التحرير، ولحظة في عزلة الكتابة، فأيّهما تختارين؟
وحيدة المي (تبتسم):
أختار العزلة. الغرفة التي لا يسمع فيها أحدٌ أنين الحبر، حيث يمكن للعبارة أن تُولد بلا مكياج، وبلا توقيت محدد للنشر. الصحافة تعلّمني الانضباط، لكن الأدب يعلّمني الحرية.
س: عايشتِ تحولات المشهد الثقافي التونسي عن قرب، ككاتبة وصحفية وفاعلة فيه. كيف تصفين هذا المشهد اليوم؟
وحيدة المي:
المشهد الثقافي التونسي أشبه بجغرافيا متكسّرة: فيه ما يُبشّر، وفيه ما يُقلق. بعد الثورة، انفتح المجال أمام الأصوات الجديدة، وبدأت تتشكل مبادرات جهوية مهمّة. لكن ظلّ هناك غياب للتنسيق، وقلّة في الرؤية الاستراتيجية. الثقافة لا تعيش فقط بالإصدارات، بل تحتاج إلى مؤسسات حاضنة، إلى نقد مسؤول، وإلى دولة تؤمن بأن الكلمة فعلٌ تنمويّ.
س: هل ترين أن هنالك قطيعة بين الأجيال الثقافية، أم أن هناك جسورًا خفية تُبنى في الخلفية؟
وحيدة المي:
في بعض اللحظات، شعرتُ أننا نكتب في جزر متباعدة. الجيل الجديد يكتب بلغة مختلفة، بنَفَس رقميّ أحيانًا، وأحيانًا بغضبٍ صامت. لكن لا أرى في ذلك قطيعة، بل محاولة لإيجاد تعبير مختلف. نحتاج فقط إلى حوارٍ غير سلطوي بين الأجيال، حيث لا يتحدث الأكبرون من منابر الوعظ، ولا يردّ الأصغرون بالقطيعة. الجسور تُبنى حين نعترف جميعًا بأننا في مواجهة زمن هشّ، وأن الثقافة ليست منافسة، بل بناء مشترك.
س: من خلال تجربتك، هل تشعرين أن المرأة الكاتبة تحظى بتمثيل حقيقي في المشهد الثقافي التونسي؟ أم أن التغيير ما زال شكليًا؟
وحيدة المي:
ثمّة تقدّم شكلي، نعم. نُشرت كتب لنساء، وتولّت بعضهن مناصب. لكن هل هذا يعكس تحولًا جوهريًا؟ لا أعتقد. ما زالت بعض القراءات تُحاكم النص من اسم كاتبته، لا من لغته. وما زال حضور المرأة في المحافل الثقافية خاضعًا أحيانًا لـ”الكوتا” غير المعلنة. المرأة الكاتبة تُسمَع حين تهمس، ويُخشى صوتها حين تصرخ. وهذا دليل على أن التوازن لم يتحقق بعد.
س: وهل تعتبرين نفسك كاتبة نسوية؟ أم ترفضين هذا التصنيف؟
وحيدة المي:
أنا أكتب من موقع امرأة تعيش في عالم غير عادل. إذا كان هذا يجعلني “نسوية”، فليكن. لكنني لا أنتمي إلى تيار أيديولوجي أو تنظيري. أكتب لأنني أرى، وأشعر، وأتذكّر. الكتابة عندي لا تحتمل القفص، حتى لو كان قفصًا ذهبيًا اسمه “النسوية”. أفضّل أن أُقرأ كامرأة تفكر وتُقلق وتُسائل، لا كناطقة باسم فئة أو أجندة.
س: هل تتابعين كاتبات عربيات تعتبرين كتابتهن قريبة من وجدانك أو أفقك التعبيري؟
وحيدة المي:
طبعًا. أقرأ لكثيرات… وكل واحدة فتحت نافذة مختلفة، لا لأنهن “نسويات” بالضرورة، بل لأنهن كتبنَ بصدقٍ هشّ. الكتابة الأنثوية التي تُغريني هي تلك التي لا تخاف من الجُرح، ولا تزيّن الندبة. لا أبحث عن بطولات لغوية، بل عن ارتباك حقيقيّ في مواجهة الحياة.
س: أخيرًا، من موقعك ككاتبة تعبر بين السرد والصحافة، بين العام والحميم، ما الذي تنتظرينه من الكتابة الآن؟
وحيدة المي (بهدوء):
أنتظر أن تُنقذني كما أنقذتني من قبل. أن تضع لي مرآة لا تشبه مرايا الآخرين، مرآة تقول لي: “أنتِ هنا، حتى حين تنسين نفسك”. الكتابة لا تمنحني أجوبة، لكنها تجعلني أطرح أسئلتي بصوتٍ لا يرتجف.
السؤال:
في “نصف قلب وضفتان”، ماذا تمثل هاتان الضفتان من منظور فلسفي عميق، وماذا تجسّدان في تجربة الذات والوجود؟
وحيدة المي:
هاتان الضفتان تمثلان قطبين متنافرين في صيرورة الوجود الإنساني، حيث تمثل الضفة الأولى لحظة التجذّر الأنطولوجي، استقرار الذات في ذاكرة الزمن الأصلي، نقطة الانطلاق التي تتعالى منها كل تجليات الوعي والهُوية. إنها طقس الوجود الثابت، الذي يستند إلى الأرضية الأولى للكينونة، حيث تتداخل الذاكرة مع الوجود، ويصبح الماضي حضورًا مهيمنًا.
أما الضفة الثانية، فهي فضاء الانفتاح على اللامعلوم، لحظة الاغتراب الإبستمولوجي والوجودي، حيث تفقد الذات تماسكها القديم وتخوض تجربة التمزق والتلاشي لتعيد صياغة هويتها في مواجهة اللامحدود. هذه الضفة تمثل حركة التأويل المستمر، التغيير الوجودي الذي يطرح السؤال اللامتناهي عن الذات والآخر.. عن الثبات والزمن.
وما يجسّده هذان القطبان هو التوتر الوجودي البنيوي بين الثبات والتحوّل، بين الجذور والرحيل، بين الذاكرة والنسق المتجدّد للزمن، حيث تتحول الرواية إلى فضاء تأملي يستكشف أسئلة الوجود والهوية في ضوء هذا الصراع الأبدي.
تعقيب..
حين تتحوّل الأمومة إلى مختبرٍ للخيال
في ليالي الطفولة الهادئة، حين كانت وحيدة المي تنقّط لحظات ما قبل النوم بقصص في آذان بناتها، لم تكن تُدرك أنها تؤسس، بهدوء الأمّ العارفة، لمجموعة أدبية ستخرج إلى النور يومًا. كل حكاية كانت تنبض بملامح طفل من أطفالها، بسلوكٍ ميّز أحدهم، بعبارة أو عادة أو انفعال. لم تكن القصص تُروى من فراغ، بل كانت تنبثق من حياةٍ تمور بالحركة، بالحب، بالدهشة اليومية.
تحوّلت لحظات الأمومة تلك إلى ورشة حيّة للكتابة، حيث تختلط العاطفة بالبصيرة، ويغدو كل موقف بسيط خامةً لحكاية مكتملة. وحين قررت أن تنشر تلك القصص، لم تكن تنشر مجرّد خيال، بل كانت توثّق تجربة إنسانية عميقة، كتبتها بروح الأمّ وموهبة الكاتبة.
وهكذا، لم تكن تجربتها في أدب الطفل عابرة، بل ضوءًا خرج من قلب البيت، ليصل إلى قلوب الأطفال الآخرين.
خاتمة تفتح على البدء..
الكتابة عند وحيدة المي ليست مجرّد فعلٍ أو مهنة، بل هي حالة كيان مستمرة، جمرٌ لا يخبو، يتوهّج في لحظات الصمت والعزلة، يحرّك الذاكرة والجسد، ويعيد صياغة الذات والواقع. هي لا تبحث عن أجوبة جاهزة، بل عن الأسئلة التي لا تنام، تلك التي تعيش في عمق الألم والحنين، في دوامة العلاقة بين الكلمة والظل، بين ما يُقال وما يُخبّأ.
وحيدة المي تكتب لكي تُحرّر ما لا يُرى، لتمنح الصوت لمن صمت، ولتواجه الزمن الذي يمرّ بخفّة بينما القلق يبقى متربّصًا في زوايا الروح. في حضورها الكتابي، نكتشف كيف يمكن للكلمة أن تصبح جسدًا ينبض، وذاكرة تُلامس الحاضر، ورغبة بيضاء لا تتوقف عن الاشتعال.
وبينما تستمر رحلتها بين الحبر والورق، تبقى الكتابة، كما قالت، “جمرًا لا يخبو”؛ حكاية مفتوحة على الوجع، على الحب، وعلى انتظار لحظة يولد فيها الصوت الحقيقي، بلا تزييف أو خوف.
عمّار الطيب العوني
تونس – ربيع 2025.