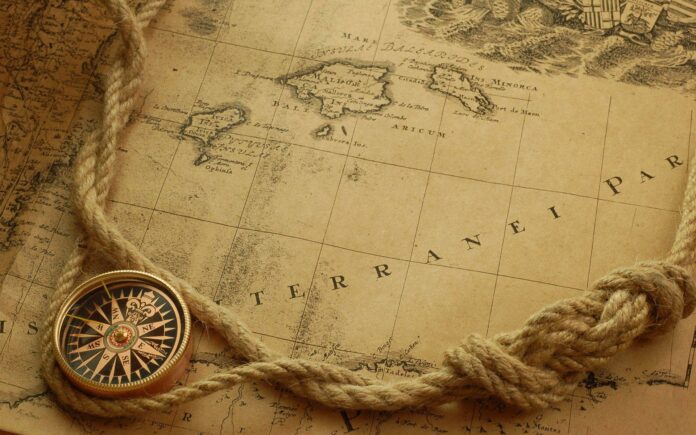الكاتب النّاقد: حسني عبد الرّحيم
تعد مقولة الشاعر الانكليزي “كيبلينغ” نهاية القرن التاسع عشر “الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا أبدا”. الركود الشرقي والاستبداد الشرقي مفهومان ربما مرجعيان في الدراسات الغربية للعالم القديم والحديث وليس” برنارد لويس ” آخر السلسلة! وحتى محاجة “ادوارد سعيد” الصحيحة ضده لن توقف هذا التثبت في العالم الغربي وهذا التثبت قد شكل في مرحلة الاستعمار مبرّرا للغزو!
“نعبد ماكان عليه آبائنا” و”كلّ مُحدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار” ربما تكونان التعبيرات المركزية في المحافظية التي تربينا عليها وهو ما نسميه أحيانا أصولية دينية وهناك كتابات ومواقف عديدة تلخص ذلك المنحى في التفكير وخاصة ان العصر الحديث والوسيط لم يشهدا ثورات جذرية عميقة في المحيط العربي- إسلامي بفعل الركود الذي تركته على البنية الاجتماعية نمط الإنتاج الخراجي والاستبداد الشرقي فقد كانت المحافظية هي المكون الرئيسي للدول والمجتمعات الشرقية وهذا ليس من فعل الامبراطورية العثمانية ولا الإسلام كدين فمجتمعات أسيوية وشرق أوربية لم تكن خاضعة للعثمانيين وتدين بتخريجات متنوعة من المسيحية الشرقية كانت في نفس الوضعية حتى المجتمع اليوناني والبلقان واللذان كانا مهدآ للفلسفة والفكر الاغريقي قبل انتقاله لمدرسة الإسكندرية ومكتبتها التي أحرقها رهبان مسيحيون!
“إدموند بروك” و”چوزيف دي ميستر” مفكري المحافظية الاوربية الحديثة وهما مؤلفان وعملا كرجال سياسة ومسؤلين في دولهم وكلاهما ليس من الوطن الأصلي بل “بروك” أيرلندي وميستير من مملكة ساردنيا! تزامنا مع الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية الكبرى وعلى عكس المتصور كان” بروك” مؤيدا للثورة الامريكية وخصم للثورة الفرنسية بينما “دي ميستير” من انصار عودة الملكية المطلقة على يد” البوربون” بعد سنوات الثورة وهزيمة بونابرت !
هناك ربط بين المحافظية والدين وهو صحيح وخاطئ بنفس الوقت فكل الفكر الاجتماعي حتى القرن التاسع عشرانطلق من أرضيات دينية سواء في الشرق او في الغرب ولم يتغير ذلك إلا بحدوث حركات التوير في الغرب! فهوبز ولوك وكانت ومارتين لوثر وديكارت كانوا متدينين مثلهم ك”عبد الرحمن أبن خلدون” و”أبو حامد الغزالي “وابن رشد” !كان الخروج من الإطار الديني المؤسسي يعني العزلة كما حدث للفيلسوف اليهودي “باروخ سبينوزا” وقبله ل “جاليليو” و”كوبرنيكس”.
القديم صالح لإنه تم اختباره في الحياة الواقعية والتنظيم الاجتماعي “هذا جوهر محاجات “بروك” و”دي ميستير” وليست مفارقك لجوهر محاجاة” الغزالي” و المحافظية الإسلامية وليست مسالة متعلقة بألتفكير الشرقي الراكد ولكنها تشكل عمود للتفكير الاجتماع والسياسي والبيئي في الغرب ذاته في العصر الحديث.
كتاب وحتى مفكرين من كافة الاختصاصات والنحل والمذاهب يعزون المحافظية للدين وهذا مخالف للتاريخ والواقع الذي ندرك بعض جوانبه بغض النظر عن تنوع سرديّاته Narrations السائدة فالاتجاهات المحافظة حاليا أكثرها علماني وكثير من الحركات التحررية كانت بوازع ديني مثل الكالفينية-البروتستانتينية التى احدثت تحول برچوازي عميق للأخلاق والثقافة في المانيا ومعظم أوربا(ماكس فيبر :الأخلاق البروتستانتينية وروح الرأسمالية) وامتدت للعالم الجديد في الأميركتين.
هذا المنحى نراه في بعض المعارضات الشيعية والسنية (القرامطة ٠الخوارج. الإباضية وخلافة) والتي لم تتحول لتيار رئيسي لأسباب اجتماعية وليست فقهية! حين كان الدين هو الإطار الممكن للتعبير عن الرغبة في التغيير والتمرد! ونستطيع تصور ذلك بالنسبة لمجتمعات شرق آسيا حيث الكنفوشيوسية شكلت إطارا للتفكير حتى بإمكان البعض وضع” ماوتسي تونج” ضمن هذه التقاليد مع واجهة ماركسية! والأدب والفن الياباني مع التحديث المتسارع قبل وبعد الحرب العالمية الثانية يمتلأ بأيقونات الثقافة التقليدية التاريخية والمحافظة.
الدين Religion مختلف نوعا عن التدينيةReligiosités! فالأخيرة تشتمل تثبيتات ومواقف لتيارات علمانية وحتى ملحدة وكذلك أيديولوجيات معاصرة كالليبرالية والشيوعية والشعبوية والفوضوية!
المحافظيّة الكلاسكيّة منذ القرن السابع عشر في الغرب كانت رد فعل على افكار التنوير والتصنيع فيما بعد والتمدين وتراجع الريف و صعود ليبرالية التجارة الحرة ويمكن تلخيص مبادئها الرئيسية في: ارتباط الحرية بالتملك- السلطة الهيراركية- الاسرة النووية التقليدية-المؤسسات الدينية المنظمة – وكانت آخر تمظهراتها الفكرية هي الرومانسية الألمانية ومن نواحي معينة الفليسوف الأشهر “مارتين هايدجر” والتنظيرات العضوية التي واكبته وانتجت في النهاية الحكم النازي ذو التوجهات الأصولية الجرمانية.
الحرب العالمية الثانية كانت نقطة تحول إذ أن الهزيمة قد لحقت بالتيار المحافظ لكن بعد الحرب حازت الأحزاب الديموقراطية المسيحية السلطة في غالبية البلاد الخاسرة وهي أحزاب يمين وسط محافظة! بينما انتقلت قطاعات من اليمين المسيحي لمواقع ابعد نظرا للكارثة الديموغرافية التي انتجتها الحرب والتصنيع الشامل وتهديد القيم التقليدية ونتج عن هذا اليمين المسيحي البروتستانتي الأصولي بأفكاره الألفية وشبه الفاشية بواعظيها الكارزميين في الولايات المتحدة وكذلك أمريكا اللاتينية وعلى الاخص البرازيل والارجنتين والتي نشرتها محطات الراديو وتعتمد الدعم المالي الكبير من مؤسّسات مالية ومراكز بحوث مؤثرة ” هارتيچ فوانداشن” ومئات المؤسسات والكنائس المنظمة والممولة من قطاعات رأسمالية تقليدية كصناعة الصلب والأخوة “كورش” في الولايات المتحدة.
النصف الثاني من القرن العشرية شهد على الجانب الغربي حرب فيتنام وتداعياتها في الجامعات الأمريكية وحركة 68 في فرنسا بأفكارهما التحررية وكذلك تغير نمط الحياة في الغرب وتوسع مدى الحريات الفردية والثقافة الجماهيرية والعقلانية ونمط حياة الهيبي واليوبي، ضمن هذه الثقافة جديدة العابرة للطبقات والقارات وكذلك الحركات النسوية والجندرية والتنوع الجنسي.. ما سمي آنذاك بالثورة الجنسيّة وكان كل ذلك يهدد المفهوم المحافظ عن المجتمع وخاصة مسألتي الاسرة والسلطة!
عامل هام للهلع الثقافي في الغرب هو الهجرة من بلدان ذات ثقافات مختلفة سواء لأوروبا أو لأمريكا. بعد الحرب كانت موجات الهجرة لتعويض العمالة المفتقدة بعد هلاك الملايين وهى على العموم كانت منظمة لكن الكوارث وعدم الاستقرار في بلدان أفريقية ولاتينية دفع عشرات الملايين للبحث عن ملجأ دون حاجة ضرورية لهم في سوق العمل وأسهمت القوانين الاجتماعية لما بعد الحرب والتي كانت محصلة نضال لعقود في بقاء المهاجرين غير القانونيين في الظل وتحولهم إلى عاطلين دائمين يعيشون في اوضاع شبيهة بحالة الطبقة العاملة الإنجليزية في القرن الثامن عشر وتحولت ضواحي المدن المتروبولية إلى جيتوهات ثقافية مستديمة مما أيقظ الهواجس الهوياتية للمواطنين الأصليين تمسكا! كانت الاطروحات العنصرية مثل” الانزياح الكبير “هي مقدمة ضرورية لتكون تيارات شعبية وسياسية مثل زامر في فرنسا وترامب في أمريكا ومليوني في إيطاليا والعديد من المجتمعات الاوربية التي كانت ترحب سابقا بالهجرة لأسباب اقتصادية.
كان الانهيار في أوربا الشرقية احد عوامل صعود النظريات الهوياتية المحافظة في العودة للمؤسسة الدينية الأرذوكسيّة في عدد من البلدان وعودة شعارات ونظريات القومية المتطرّفة كما لدى “الكسندر لوجين” ويصفه البعض ب”عقل بوتين” وبولندا التي عادت للحظيرة الكاثوليكية بعد ثورة عمالية على النظام الشيوعي.
وبالعكس من تنبؤات “فرانسيس فوكوياما” بانتصار نهائي للديموقراطية في شكلها الليبرالي كان الوضع ابتدأ في التمحور حول إستقطاب جديد حول مفاهيم وقيم هوياتية تقليدية وظهرت الاطروحة الخطيرة ل”صامويل هتنجتون “صراع الحضارات” ويتضمن تعريف الغرب الثقافي بأنه” المسيحي -اليهودي” في مواجهة حتمية مع ثقافات اخرى تمتد ما بين الإسلامي والكونفوشيوسي .
خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين شهدنا صعود للمحافظة في مواطن الليبرالية الغربية في بريطانيا والولايات المتحدة وغالبية الدول القارية كما كنا شهدنا محافظين في دول الاتحاد السوڤييتي السابق ومناطق سيطرته في شرق أوربا أخذت طابع العودة للدين ومن ضمنه الأزذوكسي والكاثوليكي والإسلامي الستي والشيعي! وتمثل الأصولية الهندوسية الهندية مثال صارخ على عودة الهوياتية العنصرية في شبه قارة تزداد عمليات تحولها التكنولوجي وتحتوي ربع سكان العالم وتعج بالاختلافات العرقية والدينية.
من المفيد الإشارة للمحافظية الجديدة في العالم الأنجلو-ساكسوني والتى بشر بها مثقفين علمانيين وملحدين ويعتبر أباها الروحي الكاتب اليهودي والتروتسكي السابق
” إيرفنج كريستول”-الأب الروحي- وهو مع آخرين تحولوا من إنتظار وعد التحرر البروليتاري لينتقلوا للعودة للتقاليد معتمدين ضمن ما اعتمدوا عليه آراء وتخريجات
” أدموند بروك” و”دي ميستير” من قرون ولت وانقضت وكانت آنذاك رد فعل على الرأسمالية الصاعدة ! وكأنك يا “فولتير” لا رحت ولا جيت!
كانت الريجانية والتاتشرية هما قمة جبل الجليد الظاهر في صورة سيطرة سياسية ولم تكن هي المحرك الأصلي الذي تديره أصوليات متنوعه بعضها ديني وبعضها علماني وملحد..، ويمكن وصفها بالأصولية الإمبريالية وليست الصهيونية السياسية الحالية غير عنصر ضمن هذا السياق!
الأصوليات الدينية من كافة الاصناف والأديان (اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية والكونفوشيوسية) صارت تسيطر على حركات شعبية جماهيرية واسعة وتسيطر سياسيا في بلاد متقدمة صناعية كما في بلاد زراعية وهي ليست طارئ لكنها ربما عودة للاوعي المقموع بحسب “سيغموند فرويد”.
هل هي مرحلة مؤقته ورد فعل زمني مرتبط باختلالات وقتية معينة ضمن النظام العالمي السائد حاليا وستزول بالضرورة بزوال مسبباتها؟ أم هي تعبير عن تغير هيكلي في نظام-الفوضى للعالم المعاصر وقد ينتج عنها حروب شاملة وتهديدات بالفناء هذا ما سيتضح خلال العقود القادمة. هل سيصير العالم ما بعد حداثي منفتح على حكايات متنوعة أو” أبو كاليبسي”تديره ربوتات” إيلون ماسك” الفضائية عن بُعد من المريخ مع صورة “أخ أكبر “لـ”دونالد ترامب” على كل الشاشات وموجات الأثير؟