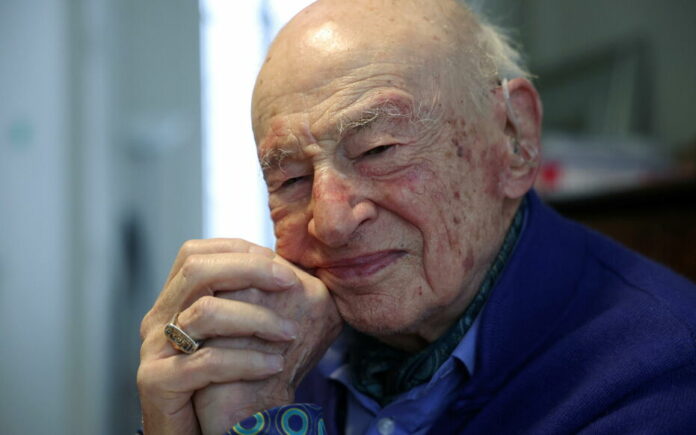ترجمة المنتصر الحملي
حاولت أداء «رسالتي» بوصفي مثقّفا في السّعي إلى احترام تعقّد القضايا واستعادة هذا التّعقّد أثناء التّشخيص وإبداء الرّأي، وإلى تجنّب المغالطات والهستيريا. إنّ هذه الرّسالة، الّتي ما فتئ تعدّد وظائفها يزداد وضوحا بالنّسبة إليّ، منذ عام 1956 إلى اليوم، هي الّتي سأحاول صوغها فيما يلي.
رسالة المثقّف
الوعي بأنّ المثقّف، بعيدا عن مسألة الخيار بين الالتزام أو البرج العاجيّ، هو فاعل في لعبة الحقيقة والخطأ الّتي هي في قلب لعبة التّاريخ البشريّ.
الهوس الدّائم بمشكلة الخطأ. فالخطأ هو الخطر الدّائم الدّاهم على المعرفة والفكر 5، ومن ثمّة على المثقّف. إنّ الخطأ الّذي يمثّل عبئا ثقيلا على عصرنا بشكل خاصّ هو الخطأ الإيديولوجيّ. فقد راكم المثقّفون من خلال الإيديولوجيا أكثر الأخطاء فتكا. ومن هنا تأتي الحاجة إلى اليقظة المستمرّة للكشف عن جميع مصادر الخطأ المحتملة والحذر على الدّوام من تسلّل الخطأ بشكل ماكر.
تشتمل مكافحة الخطأ على رصد الأساطير الّتي تحرّكنا، ولكنّها مكافحة لا يمكن أن تعني «إزالة الغموض» أو «إزالة الأسطورة» أو «نزع الإيديولوجيا». فالقضاء على الأسطورة لا يمكن أن يكون إلاّ مجرّد وهم، لأنّ كلّا من الأسطورة والخيال يمثّلان جزءا من الواقع البشريّ.
القضيّة الحقيقيّة هي الإقرار بالطّابع الأسطوريّ لأساطيرنا، واختيارها بما هي كذلك، وجعل عقلانيتنا تدخل في حوار مع أساطيرنا.
تشتمل مكافحة الخطأ أيضا على الدّراسة المتأنّية للمعلومات المختلفة والوثائق المتناقضة، ولكن دون أن تقتصر على التّثبّت من الوقائع. إنّها تفترض الإرادة المعرفيّة لاحترام تعقّد الظّواهر البشريّة والاجتماعيّة والتّاريخيّة، من أجل تجنّب الأطروحات البرّاقة ولكن العبثيّة وأحاديّة الجانب، وتجنّب المغالطات أيضا.
إنّها تقتضي الحرص على محاولة فهم مصيرنا.
الأَشْكلة La problématisation بوصفها النّشاط الأساسيّ للمثقّف، بدلا من «النّقد» الّذي يقوم في الحقيقة بانتخاب أهدافه بشكل تعسّفي ولا يعرف كيف ينقد نفسه.
ضرورة ترك موقع القاضي الفاتق النّاطق في كلّ شيء.
إنّ من واجب المثقّف أن يحرص على التّخلّي عن مركزيّته ويحاول إيجاد وجهة نظر فوقيّة تجاه البديهيات القائمة والأفكار الجاهزة. وهذا يشمل الحاجة إلى الفحص الذّاتيّ الدّائم ومقاومة الهستيريات الجماعيّة الّتي تدّعي دائمًا أنّها تعبّر عن سخط عادل وفاضل. من البديهيّ أنّ تجنّب الهستيريا لا يعني رفض السّخط العادل. ولكن يبقى من البديهيّ أيضا أنّ السّخط لا يمكن أن يحلّ محلّ الفكر.
ضرورة نشر أفكار نوعيّة، أي مبادئ مولّدة للمعرفة والفهم، بدلا من الأفكار العامّة.
الحفاظ على إيتيقا المناظرة في مقابل إيتيقا الرّفض.
حاولت الاحتفاظ بهذه الإيتيقا، الّتي قمنا بإرسائها في مجلّة أرغيمون Arguments لأقاوم الاتّجاه الّذي يحوّل المواجهة بين الأفكار إلى معارك لا يراد فيها (وربّما لا يستطاع؟) فهمُ الأفكار المتعارضة ولكن تشويهها. إنّ المثقفين نادرا ما يمارسون ما كان يجدر بثقافتهم أن تطوّره في العادة: ونعني بذلك الاهتمام بخطاب الآخرين، والقدرة على الاستماع إلى حجّة ما دون تشويهها. نراهم على العكس من ذلك، يحقّرون من مقاصد أقوال الآخرين أو أفعالهم ويحطّون من شأنها، ونرى لديهم «سوء نيّة»، و»عدم نزاهة» إزاءها. فما الفائدة إذًا من قراءة مونتاني ولابرويير وفرويد؟ إنّه لا بدّ من الاعتراف بالحقّ في الكلام للمفرِّقين والمُنكِرين، أي للشّيطان، بما أنّه هو العقل الّذي ينكر والقوّة الّتي تفرّق في آن واحد.
التّفكير في الإفقار الثّقافيّ وبذل الجهد من أجل التّجميع الثّقافيّ.
دعونا نتذكّرْ التّشخيص الّذي سبق لي أن صغته بالفعل: «إنّ الثّقافة تعاني من التّفكّك. فمن ناحية، هنالك «علوم إنسانيّة» مفقَّرة لا تعرف كيفيّة الاتّصال بمصادر التّحقّق (العلوم) ولا بالمصادر اليوميّة للمعرفة (وسائل الإعلام) وتفكّر من فراغ. ومن ناحية أخرى، هنالك ثقافة علميّة عاجزة، مبدئيّا ومنهجيّا وبنيويّا، عن تصوّر المشاكل في شموليتها وعن التّفكير المنعكس على نفسها. ومن ناحية ثالثة، هنالك ثقافةُ وسائط الإعلام، المتعاملة يوميّا مع العالم والحدث والمستجدّ، ولكنّها لا تمتلك سوى وسائل تفكير ضعيفة.»
في كلّ مكان إذًا، في العلوم كما في التّقنيات والعلوم الإنسانيّة ووسائل الإعلام، تسود أفكار عامّة جوفاء، أفكار رنّانة ومدوّية هنا (في العلوم الإنسانيّة)، مستترة ولكنّها منتشرة في كلّ مكان هناك (في العلوم)، ومفروزة حسب قيمتها الاستهلاكيّة والتّجاريّة في مكان ثالث (في وسائل الإعلام). في كلّ مكان، تتأكّد الحاجة إلى التّفكير: فـ»المنظّر الإيديولوجيّ غير قادر على التّفكير، ليس فقط في الواقع، ولكن أيضا في الإيديولوجيا عموما وفي إيديولوجيته خصوصا، ورجل التّقنية غير قادر على التّفكير ليس فقط في المجتمع، ولكن أيضا في التّكنولوجيا. والعالِم لا يستطيع التّفكير ليس في البشريّة فحسب، ولكن في العِلم أيضا1. […] في كلّ مكان، نرى دَفعة حضاريّة هائلة، مع نمط الحياة الحضريّ بكلّ أبعاده، من منطق الآلة الاصطناعيّة، إلى الضّغوط الموقوتة، إلى الأعباء الزّائدة، إلى الاحتياجات الفوريّة، إلى التّسرّع، إلى الضّغط، إلى الإرهاق العصبيّ والجسديّ، وكلّها تنحو إلى القضاء على أيّ إمكانيّة للمراجعة، والتّفكير، وإعادة التّفكير».
على المفكّر إذًا أن يحمل على كاهله أصعب مهمّة لم يسبق لها أن وجدت في تاريخ الثّقافة: مهمّة مقاومة سائر القوى الّتي تحطّ من قيمة التّفكير، والاقتدار على بناء أفكاره اعتمادا على مساهمات العلم المعاصر الرّئيسيّة من أجل محاولة التّفكير في العالم والحياة والإنسان والمجتمع.
مقاومة الهمجيّة.
ثمّة همجيّات عديدة: همجيّة آتية من أعماق العصور وتتجلّى في الكراهية والمذابح والازدراء والإذلال. وهمجيّة مجهولة الهويّة تماما، مدمّرة للبشريّة والمسؤوليّة والعيش المشترك، وهي تنمو مع توسّع العالم التّكنو-بيروقراطيّ؛ وهمجيّة مدمّرة للبشريّة أيضا تنمو مع اكتساح الرّبح لجميع المجالات والتّسليع في كلّ شيء؛ وهمجيّة سياسيّة محض بلغت ذروتها المعاصرة مع الكليانيّة totalitarisme. إنّ هذه الهمجيّة الأخيرة تولد من جديد في أشكال جديدة، في حين أنّ الهمجيات السّابقة هي في أوج نشاطها الآن وقد تضافرت مع بعضها البعض. وهكذا، تصبح المقاومة واجبا دائما على المثقّف.
حشد جميع المؤهّلات الفكريّة في الأنشطة السّياسيّة
يمكن التّعبير عن الدّرس العظيم المستفاد من ثلاثينيات القرن العشرين وتسعينياته كما يلي: «لم يعد بإمكاننا، أعني لم يعد ينبغي لنا، أن نترك الجزء الأكثر غموضا وطفوليّة وانفلاتا فينا حكرا على السّياسة».
الوعي بالبشريّة وإيتيقا الكونيّ الملموس
إنّ التّطلّع إلى الكونيّة ينطوي على خطر فقدان الاتّصال بالواقعيّ الملموس، وقد تؤدّي إرادة فرض حقيقة كونيّة إلى الإرهاب. وعلى العكس من ذلك، فإنّ الدّفاع عن الواقعيّ الملموس يؤدّي إلى الخصوصيّة المغلقة، وحتّى إلى الأسطورة المجرّدة للملموس الواقعيّ (أَسْطَرَةُ الأرض والدّم). بالفعل، كان طموح المثقّفين المعرفيّ والإيتيقيّ، بشكل ضمنيّ بين التّنويريين الألمان Aufklärer في القرن الثّامن عشر، ثمّ بشكل صريح بين كبار الرّومنطيقيين وخاصّة هوغو، هو أن يأخذوا الوعي البشريّ على عاتقهم. لقد أراد رومان رولاند Romain Rolland، منذ بداية حرب عام 1914، وضع نفسه «فوق الصّراع» الفرنسيّ الألمانيّ كي يتكلّم نيابة عن البشريّة. وكان اعتناق الماركسيّة بمثابة التزام بالعقيدة الّتي تولّت مسؤوليّة الجنس البشريّ. فأولئك المثقّفون الّذين انتسبوا إلى الشّيوعيّة والتّروتسكيّة قد فعلوا ذلك من أجل قضيّة البشريّة.
كما تحدّث كامي Camus نيابة عن البشريّة حينما عبّر عن رعبه من قنبلة هيروشيما. ولكن كم من حالات اللاّوعي والأخطاء والفظائع قد تمّ ارتكابها فيما كان يعتقد مرتكبوها أنّهم يخدمون الجنس البشريّ! في جميع الأشكال المختلفة للشّيوعيّة، تمّ التّلاعب بقضيّة البشريّة من قبل خدمها العميان.
بعد أن أدرك بعض المثقّفين في السّبعينيات الخطأ المأساويّ، كرّسوا أنفسهم لحقوق الإنسان. مع هؤلاء المثقّفين المتفرّقين، علاوة على عدد قليل من العقول في العالم الثالث، قام نادي روما وأطبّاء بلا حدود ومنظّمة العفو الدوليّة، ولكن على بُعد واحد، بدور ضمير البشريّة.
هل يجب أن نتخلّى عن أيّ نوع من الكونيّة خوفا من الوقوع في التّجريد والخطأ؟ كلاّ، على العكس من ذلك، نحن في عصر مجتمع وحدة المصير البشريّ. وهناك قضايا أساسيّة متعلّقة بالحياة والموت يشترك فيها جميع البشر – فالكونيّ هو شيء واقعيّ ملموس، ملموس جدّا لدرجة أنّ البشريّة، المتحدّرة من جذع مشترك، والحاملة لطبيعة مشتركة، لها جذورها المشتركة في كوكب الأرض. ومن الآن فصاعدا، يجب تعميق وتوسيع الحاجة إلى الجذور، الّتي تدفع الكثير من الشّعوب والأفراد إلى الانطواء على العرق والدّين الفريدين، في الاعتراف بالمجتمع الأرضيّ للبشر. يمكننا، ويجب علينا، أن نعيد شحن أنفسنا في الأرض – الوطن، الّتي هي كوننا الفريد والواقعيّ الملموس على حدّ سواء.
أن تكون مثقّفا هو أن تثبت لنفسك أنّك كذلك، وهذا يعني أن تكلّفها برسالة: رسالة ثقافيّة، رسالة ضدّ الخطأ، رسالة ضمير البشريّة. هذه هي الرّسالة الّتي التزمتُ بها التزاما راسخا. وأنا أعرف جيّدا أنّني لم أستوفها حقّها بشكل كامل، وهو ما كان يجب أن يجنّبني نوعا من الرّضا الذّاتيّ الّذي لم أستطع رغم ذلك أن أمتنع عن التّعبير عنه.
دفاعا عن العلوم الإنسانيّة
إنّه لا يشرّفني فحسب، بل ويسعدني للغاية أيضا أن أتوجّه لكم برسالة «أب روحيّ» بمناسبة ترقية الدّفعة الجديدة من الدّكاترة.
لماذا سعيد؟ لأنّ هذه المناسبة تسمح لي بالتّعبير عن اقتناعي بالأهمّيّة المتزايدة للعلوم الإنسانيّة في وقت يهيمن فيه تصوّر للمعرفة ينزع إلى اختزالها إلى مجرّد ترف فكريّ. إنّ القلق يساورني من تراجع تدريسها لصالح العلوم المجهَّزة بصرامة الحساب، والتّقنيات ذات النّجاعة العمليّة.
يخضع هذا التّصوّر لفكرة أنّ الجامعة يجب أن تُكيّف ثقافتها مع احتياجات المجتمع الفوريّة، والحال أنّ رسالة الجامعة، حسب رأيي، هي بالأساس تكييف المجتمع مع الثّقافة. هذه الثّقافة، وأعني هنا ثقافة العلوم الإنسانيّة، هي ثقافة عَبرتاريخيّة يتجاوز مؤلّفوها وأعمالُها حدود الزّمن والعصور والمجتمعات، لتتجدّد فضائلُها في كلّ مرّة. ضعوا في اعتباركم أنّ هيرقليطس Héraclite، وإمبيدوكليس Empédocle، وأفلاطون، وأرسطو، لا يزالون مُحدَثين، وكذلك هو الحال مع هوميروس ويوربيديس، وأنّ كلّ شعراء القرن التّاسع عشر العظماء وكتّابه ما زالوا أحياء، في حين أنّ جميع النّظريات العلميّة للقرن التّاسع عشر قد استُغنيَ عنها، باستثناء نظريّتي التّطوّر والدّيناميكا الحراريّة اللّتين تمّ في الحقيقة تعديلهما منذ ذلك الحين بشكل عميق للغاية.
حاشا أن أكون ممّن يُنقصون من قيمة الثّقافة العلميّة. فلطالما اعتقدت أنّه يجب إدماج إنجازاتها العظيمة المتعلّقة بالكون والحياة في ثقافة العلوم الإنسانيّة، ليس فقط لأنّنا موجودون في هذا الكون المادّيّ وفي عالم الحياة، ولكن أيضا لأنّ الكون المادّيّ وعالم الحياة موجودان فينا.
لكن في هذه الحالة من الاندماج، ستجلب ثقافة العلوم الإنسانيّة إلى التّخصص العلميّ المفرط شيئا خاصّا بها وغائبا عنه: إنّه الانعكاسيّة.
أودّ أن أذكّركم بأنّ فيلسوفا هو من اكتشف وجود ثقب أسود عملاق في قلب الثّقافة العلميّة. إنّه هوسرل الّذي أظهر في محاضرته عن أزمة العلوم الأوروبّيّة، أنّ العلم، مهما كان واضحا وبارعا في سعيه إلى الموضوعيّة، هو عاجز عن رؤية الذّاتيّة، بما في ذلك ذاتيّة العالِم نفسه، وهو لا يملك الوسائل اللاّزمة للتّعرّف على القوى الهائلة الّتي أنتجها العلم المعاصر والسّيطرة عليها.
بينما تضيء العلومُ العديدَ من المناطق المظلمة لأذهاننا، فإنّ الفلسفةُ، بمساعدة التّاريخ وعلم الاجتماع، تسمح بإنارة العديد من المناطقَ المعتمة في العلوم.
أودّ أن أقول أيضا إنّ الرّواية والمسرح والسّينما لا تمنحنا فقط عواطف جماليّة، والّتي تمثّل جزءا من الجودة الشّعريّة لحيواتنا. إنّها تعطينا أيضا، من خلال هذه العواطف، معرفة بالعالم البشريّ لا يمكن لعلم الاجتماع أو علم النّفس تقديمها لنا، لأنّها تجعل من أفراد واقعيين يعيشون، في بيئات واقعيّة، بكلّ خصوصيتهم. إنّ للأدب هذه الميزة المتمثّلة في كونه في نفس الوقت وسيلة للمعرفة وغاية عاطفيّة جماليّة.
علاوة على ذلك، أظهر أنطونيو داماسيو Antonio Damasio أنّ العاطفة مرتبطة بشكل لا ينفصم بالنّشاط العقلانيّ للعقل. بل إنّها فضلا عن ذلك تساعد على نقل المعرفة. قال أيزنشتاين Eisenstein متحدّثا عن أفلامه إنّه كان يريد من صُوَرٍ أن تنقل مشاعرَ من شأنها أن تولّدَ أفكارا.
يبعث فينا الشّعر عاطفة نقيّة تسمو بكينوناتنا. ومع ذلك، فإنّ هذه القدرة على خلق عاطفة شعريّة تنضح بها الموسيقى والأدب والرّسم والفنون جميعا. هذه العاطفة الجماليّة هي جزء من جودة الحياة الشّعريّة الّتي تجعلنا، إذ تمنحنا الحماسة والعمق والتّشاركيّة، نقاوم هيمنة الحساب المبتذل والمصلحة الأنانيّة في الحياة اليوميّة.
أنتقل الآن بإيجاز إلى العلوم الإنسانيّة. إنّ جميع الدّعاوى بعلميّتها اعتمادا على نموذج الفيزياء الحتميّة القديمة قد ذهبت أدراج الرّياح. فهذه العلوم الإنسانيّة لا تنطوي على تعقيد خاصّ بالوقائع البشريّة فحسب، ولكن أيضا على إشكاليّة مخصوصة بما أنّ الباحثين في هذه التّخصّصات هم بشر يشتغلون على البشر، ومن هنا تأتي الحاجة الدّائمة إلى الفحص الذّاتيّ والانعكاسيّة. إنّها تشتمل على جزء لا غنى عنه من كتابة المقالات. لذلك فهي في آن واحد جزء من الثّقافة العلميّة ومن ثقافة العلوم الإنسانيّة، وهذا الوجه المزدوج يُعتبَر ثروتها.
يبدو لي أنّ مهمّة العلوم الإنسانيّة هي الكشف عن التّعقيدات البشريّة، الّتي هي تعقيدات مخصوصة ولكنّها مطموسة بسبب الفصل بين التّخصّصات. كما أنّ لديها مهمّةُ مراجعة بعض المفاهيم الأساسيّة، مثل مفهوم التّنمية.
أخيرا، أردت أن أخبركم بأنّ كلّ شيء يتجاهل العلوم الإنسانيّة أو يزدريها إنّما يرقى إلى الهمجيّة الفكريّة.
فصل من ترجمتي لأحدث كتاب ألّفه عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسيّ إدغار موران، وهو بعنوان «لحظة أخرى أيضا Encore un moment…». سيصدر الكتاب قريبا عن دار 7 للنّشر والتّوزيع.